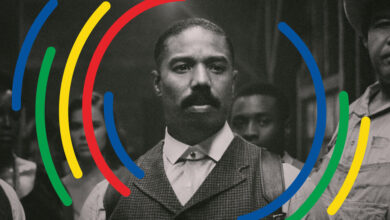ما الذي يمكن أن تُضيفه الرواية إلى فهمنا للتاريخ؟
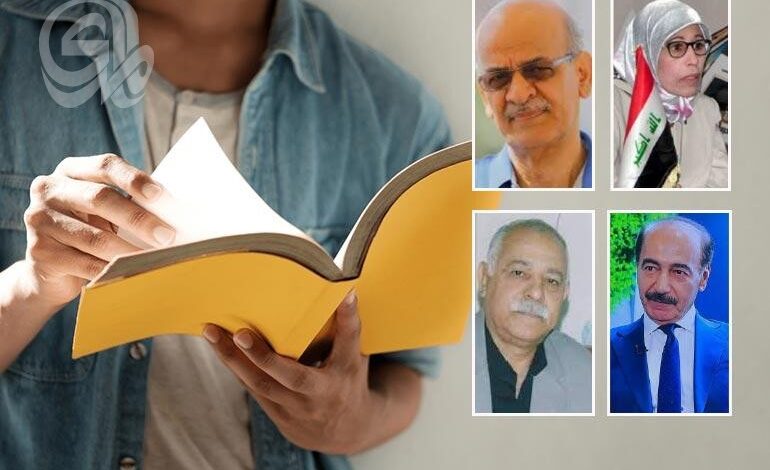
علاء المفرجي
في كثير من الأحيان، لا تنقل كتب التاريخ الرسمية كل ما حدث فعلاً، بل تركز على روايات معينة وتتجاهل أصوات الناس العاديين أو الجماعات المهمّشة. هنا يأتي دور الرواية، التي تفتح المجال لسرد حكايات منسية وتقديم وجهات نظر مختلفة عن الماضي. من خلال الرواية، يمكننا أحيانًا أن نقرأ التاريخ من زوايا جديدة، نسمع أصوات من لم تُتح لهم فرصة الكلام في السجلات الرسمية.
السؤال: ما الذي يمكن أن تُضيفه الرواية إلى فهمنا للتاريخ؟ وهل ترى أن الروائي يسهم في تقديم «تاريخ بديل» أو مختلف عن الذي نقرأه في الكتب الرسمية؟
الناقدة د. نادية هناوي:
إن أحداث التاريخ ليست وقائع مسجلة وإلا صارت صفحات التاريخ فوضوية، وإنما هي قصص محبوكة يصعب العثور على القصة الحقيقية للواقعة داخل الأحداث المسرودة على صفحات التاريخ الرسمي أو العام. وبذلك تظل الحقيقة جزئية، لأن المؤرخ لا يوثق ما حصل بقدر ما يفسره. هنا يظهر الدور المهم لعمل كل من الذاكرة الثقافية والمخيلة السردية في الإفادة مما تركه المؤرخون من ثغرات وفجوات، سكتوا عنها لأنها تكشف خسارات ونقاط ضعف تضر بالمنتصر، أي الذي كُتب إليه التاريخ. والوقائع المنسية والمسكوت عنها كثيرة، لأن التاريخ أسدل أستاره عليها وحجب ظهورها للملأ. وما ينفض الغبار عن تلك الوقائع الآفلة هو عصرنتها بالحاضر الذي هو مراد الروائي. والغاية من استعادة الماضي الغابر جعله وسيلة لهدف رئيس هو الواقع الحاضر ترميزا إلى فواعله وطبقاته وتياراته. ومن المؤكد أن إسهام الروائي في كتابة المسكوت عنه تاريخا يعني ملء الفجوات وإظهار الخلفيات الخفية، وتشكيل تفاصيل اللوحة الكاملة للأوضاع الإنسانية. وهذا يكون بطريقتين: الاولى هي السرد الزماني المحكوم بالعلاقات والتحولات التاريخية( وهو أمر أساس في كتابة الرواية التاريخية) والطريقة الثانية هي السرد الزماني المحكوم بالمتخيل التاريخي( وهو أمر خاص برواية التاريخ )
وإذا كانت الرواية التاريخية تقتصر في عملية استنهاض أفول الواقعة التاريخية على تدوير ما أرشفه المؤرخون من أحداثها داخل المجلدات والسجلات والحوليات، فإن رواية التاريخ تستثمر الوقائع التاريخية بقصد سحب الحاضر ليكون جزءا من الماضي الغابر. على عكس الرواية الواقعية التي كثيرا ما يُخلط بينها وبين الرواية التاريخية ورواية التاريخ. وللتفريق نقول إن في الرواية الواقعية يكترث الروائي بحركة الواقع التأريخية التي حاضرها معيش أو منصرم أي أن الرواية الواقعية تقوم بتمثيل الماضي القريب في حين تختص الرواية التاريخية ورواية التاريخ بتمثيل الماضي الغابر.
الروائي فلاح رحيم
ستكرر ما صار يُعدّ من البديهيات. يواجه الروائي العراقي في يومنا هذا حقيقة أن الحياة في العراق قد بلغت حدّ الإشباع السياسي. توغلت السياسة طوال عقود في كل زاوية في حياة الناس ولم تبق حيزاً لأفكار محايدة خاصة أو تأملات كونية عامة. يصعب علينا الفصل بين الفرد العراقي والحدث التاريخي الذي منحه هويته وصاغ حياته. وهذه الحالة الاستثنائية وضعت الروائي العراقي أمام مهمات استثنائية. لم يعد دوره توثيق الحياة الخاصة بوصفها منافساً للأحداث العامة مستقلاً عنها، وذلك لاستحالة الفصل بين المجالين. المهمة اليوم أصعب وأكثر طرافة، وأعني بها احتواء هذا التفاعل الاستثنائي بين العالمين الخاص والعام وتأطيره وإخضاع فوضاه المربكة لدفتي العمل الروائي. أتذكر في كتاب فيليب غورفيتش عن الحرب الأهلية في رواندا، بينما المذابح تتواصل دون توقف يدخل عليه زميل فيجده منهمكاً في قراءة رواية. يقول له: «الروايات جميلة. إنها تتوقف عند حد». وهذا ما نجده في حكايات السندباد، ننسى أن إطار هذه الحكايات هو اللقاء بين السندباد البحري والسندباد الحمال البائس الذي يعيش حياة شاقة لا فسحة للراحة فيها. يقدم له السندباد البحري ليواسيه حكايات لها بداية ونهاية، تروي مغامرات كبيرة هددت حياته لكن ما يميزها عن حياة الحمّال أنها تنتهي دائماً وتتحول إلى حكاية. لا يكتفي بهذا بل يؤكد مهمة المواساة بإعانته بالمال والولائم. هنالك مواساة في الرواية تتمثل في تمكين القارئ وهو ينتهي من قراءتها من خلق مسافة تفصله عن التجربة المأزومة وقد تكثّف وعيه بحقائقها فتتيح له متنفساً، فسحة للتأمل. وهذا ما لا يتمكن التاريخ من تحقيقه لأنه محكوم بالوقائع ومشغول بالاعتبارات السياسية في المقام الأول. أدرك الروائيون منذ القرن التاسع عشر أن مقاربة الواقع وفهمه سردياً لن يتحقق إلا باستخدام الخيال. الوقائع وحدها كثيفة فوضوية لا توفر هذا الفهم. لا ينشغل الروائي بما حدث (أي الإخبار عما حدث) حسب، بل هو ينشغل أيضاً بسؤال كيف حدثَ ما حدث؟ ولماذا يبقى يسكننا ونعاود طرح الأسئلة عنه دون توقف؟
الروائي ضياء الخالدي
ما بين الرواية والتأريخ وشائج راسخة تتمثل بالبنى المُشكّلة لكليهما، أي الأحداث والشخصيات والسرد. وهذا يجعل الرواية الأقرب إلى تتبع الوقائع التي أهملها الماضي لغايات مختلفة، منها ما يعود إلى أحداث كبرى تمت روايتها بلغة المنتصر ومنها ما يرتبط بالهامش بناسه وأفكاره. الراوية تقتفي أثر مادة تأريخية «مُهدرة» يُمكن تبيان موقعها في جسد المرويات الرسمية، وشحنها بطاقة تخييلية يكون فيها الإنساني حاضراً بقوة، رفقة زوايا نظر جديدة. كما يمكن للرواية أن تستعيد ملامح شخصية ما، تم إزاحتها عن موقع التأثير في عصرها وإعادة ترميمها عبر شذرات هنا وهناك من مرويات المناوئين لها.
وهذا يزودنا بفهم واسع في تقييم الواقعة التأريخية وتأثيرها على بنية الأفكار وحياة الناس وقتذاك. انتصارات وهزائم، وأوبئة وسبي، ودسائس وأوهام تم تصديقها. تملك الرواية القدرة على النفاذ بين كل ذلك لتملأ الفراغات التي لم تُروى. تقترب من مريض بالطاعون وأمامه أيام معدودات قبل الرحيل، أو عائلة يُقتل معيلها في صد غزوٍ فتسبى ويتفرّق أفرادها لدى المنتصرين، أو صاحب فكر جهر بآرائه المُخالفة فقُتل وبقيت أفكاره حية وأحدثت تأثيراً لدى اللاحقين.
ولأن الرواية تنطلق من التخييل والشروط الفنية فذلك يجعلها أمام تهمة عدم الوثوق بما تروي. وهذا الأمر لا يقلل من شأنها، فليس مهمة الرواية هدم وتغيير الحوادث الراسخة برأيي، وإنما عمل المؤرخ المعاصر الذي يتلمّس الدقة والحقيقة عبر ما يمليه علم التأريخ، وأن اتجهت الرواية إلى الهدم والتغير فقد ذهبت إلى مقاصد فنية أخرى. تتحرك الرواية في عالم الأفكار وهواجس الناس وصدامهم مع القوى المهيمنة في زمانهم، لهذا لن تكون تأريخاً بديلاً بقصد الإزاحة كما أعتقد، وإنما تأريخاً غير رسمي له صفة التعزيز وإنارة ما يخرج عن مهمة المؤرخ الحديث، ولغايات إبداعية بالطبع.
الروائي امجد توفيق
لا أحد على ما أظن يمكن أن يربط أحداث التاريخ بالحقيقة أي بما جرى فعلا، وأفضل المناهج التاريخية لا تدعي أنها تقول أو تتوصل إلى حقيقة الأحداث، فكل ما هناك أنها تدرس وتجمع وتقاطع الأحداث للوصول إلى نتائج يمكن أن تكون قريبة للواقع ولكنها ليست الواقع ولن تكون .. فيما يتعلق بالرواية أظن أن السؤال يفصح عن تفاؤل بدورها، كأن تكون صوت المهمشين أو الصوت البعيد عن الإملاءات الرسمية لأصحاب النفوذ أو السلطة، لكن واقع الحال وينبغي أن يكون ذلك واضحا أن الروائي ليس مؤرخا، إنه مبدع مهموم بالقيم الجمالية وتحويل الذاكرة الفردية او الجماعية الى قيمة من شيء خاص الى ما هو عام . الروائي ليس مطالبا بالتوثيق والأدلة وليس مهتما بمعايير المناهج التاريخية لسبب بسيط كونه ليس مؤرخا ولا أحد يمكن أن يملي عليه هذه المهمة .. الى ذلك لا يمكن التقليل من دور الرواية في تعميق الفهم وفتح مجالات وآفاق أوسع عبر رؤية متسعة الزاوية لحياة وصراعات الناس في الزمان والمكان الذي تتناوله الرواية، لتوفير قناعات تستند الى الوعي والى انتفاء القصد المسبق .. وأجد أن السؤال يمكن أن يتضمن الإشارة الى عشرات الروايات التي استلهمت أحداثا تاريخية ربما تعود الى مئات السنين او أكثر، هذه الروايات كونها تعتمد على مادة أولية مختلف عليها ، ولا تتوفر لها امكانات التوثيق ، فإنها لن تكون بديلا عن ما يكتبه المؤرخون ، بل ربما تحمل هذه الروايات وجهات نظر كاتبها أو قناعاته الشخصية وبذلك لا تضيف سوى أشكالا آخر إلى جملة ما تعانيه الأحداث التاريخية .. ويمكننا أن نستشهد بالدراما التلفزيونية، فهي لن تكون مصدرا تاريخيا، إذ أن هدف الفنون والابداع بشكل عام هو خلق القيم الجمالية وإشادة علاقة تلق متقدمة مع القارئ او المستمع او المشاهد، وليس البحث أو الإخلاص لما حدث في التاريخ فعلا.
الكاتب والقاص كاظم جماسي
كاتب الضرورة التي تلزمنا بالعيش المشترك مع غيرنا من البشر، على هذه الأرض، تضمر، من أجل ديمومتها، اتفاقا أو اصطلاحا على أهمية التاريخ كعلم، بكل ما للعلم الإنساني من مناهج تحليل وطرق قياس، ندون بواسطته الوقائع الحقيقية لأرثنا الماضي، فيما المحاكمة العقلية تخبرنا، بمفارقة دالة وبراهين دامغة، أن لا حقيقة هناك .. خذ، مثلا، رواية شاهدين عيانيين اثنين فقط لحدث ما، سيخبرك كل واحد منهما بواقعة مختلفة .. كما لكل منا، بصمة مختلفة، فأن لنا عدسة نظر مختلفة ورهافة سمع وأحاسيس مختلفة، وبتضافرها معا في ورشة التفكير الفردي، وبعون من المخيلة، التي من دونها سيبدو كل زاد الحديث ماسخا، ستمضي الذاكرة البشرية شوطا ابعد. على وفق ما تقدم، وبعد أن بلغت” الحكاية” شأنا متقدما فأمست” رواية” بكل ما لهذا المسمى من إكتناز وثراء في الحراك الفكري والامتاع الجمالي والحسي، فأننا نصل الى أن الفارق جد وهمي وهو صنيعة حاجتنا للركون إلى معالم خرائط عيش مشترك. يقول” عالم التاريخ” أدوارد كار: (التاريخ ليس وقائعيا على الاطلاق، وانما هو سلسلة من الأحكام المقبولة» الأمر الذي باتت الرواية وبعزم فعل المخيلة تجعله شاخصاً اليوم كما شَخصَ من قبل الحدث التاريخي. سيجيئ اليوم الذي سيكون قارا في معارفنا أن” دون كيخوته” شخصا حقيقيا، تقاسمنا معه التوق إلى الحصول على الاعتراف بالبطولة والنبالة.. مثلما سيجيئ اليوم الذي سنشير به إلى أن” ملكياديس” غجري -مائة عام من العزلة-مخترع عظيم، مثلما سنؤمن أن” الجبالي في-اولاد حارتنا-خالق أعظم.
الناقد والروائي عبد الأمير مجر
نعم، لم تعد كتب التاريخ التقليدي معتمدة في دراسة تاريخ الشعوب والدول، لأن اغلب المؤرخين لهم ميولهم او وقعوا تحت ضغوط معينة، لذا جاء الادب ليستثمر في هذا الحقل الخصب، لكن الاشكال بقي قائما، اذ صار بعض الأدباء يتناولون مراحل تاريخية معينة ويُعالجونها من خلال اتكائهم على روايات أو قصص (تاريخية)، ليعيدوا قراءتها وانتاجها، وهنا تكمن الخطورة ايضا، إذ قد يكون هذا الأديب له دوافع وأهداف معينة ويريد تمرير مقولة مختلفة، عندها يُصبح الأدب إحدى وسائل الترويج وأداة من أدوات الحروب الناعمة، وقد حصل هذا بشكل واضح خلال الحرب الباردة ومازال، حيث تسلّل التناشز العقائدي الذي طبع تلك الحقبة إلى الأدب من خلال أدباء عقائديين أو مجنّدين. فالأدب فقد الكثير من (نقائه) الانساني الذي جسّدته اعمال كبرى توزعت القرون السابقة، بعد ان ادخل في لعبة الصراع السياسي او وقع تحت تأثيره. وفي عالمنا العربي كثر الحديث مؤخرا عن سعي بعض المؤسسات الثقافية إلى استثمار الأدب لأغراض غير بريئة، من خلال جوائز مغرية تُمنح وفق ضوابط، قد لا تكون معلنة، لكنها معروفة للأدباء الذين يرغبون في الحصول على الجوائز، لمعرفتهم بمزاج تلك المؤسسات والدول التي تقف وراء تمويلها. فالأديب الذي يسعى من خلال عمله إلى طرح مقولة في واقعة تاريخية وفقا لميوله، إنما يمارس دور المؤرخ المزوّر، وليس المؤرخ فقط، ان لم يكن أمينا او بالأدق موضوعيا. وهنا تكمن خطورة الاعتماد على الأدب في قراءة التاريخ او تناوله . وشخصيا وقفت على اعمال ادبية تيقنت من عدم امانتها وان هناك غرضية مسبقة كانت وراء كتابتها وتسويقها.
الناقد والروائي حسب الله يحيى
رواية من صنع المخيلة , فيما التاريخ من صنع الواقع، نعم. الواقع لا يتناقض ولا يتضاد مع المخيلة , فمعظم الروايات الفذة واقعية , ولكن بأدوات الخيال. أما التاريخ فيقوم على وفق صورتين: ما يكتبه المنتصر، وفي الغالب لا يكون دقيقا ولا يمكن الركون الى صدفه ووثائقيته. الصورة الثانية ما تسجله الوقائع الخفية، المسكوت عنها، المدفونة، والتي تحمل صدقها وجذرها وفعلها، لكن المنتصر يغتالها ويشوهها.
اما الرواية التاريخية فهي ابنة الحدث الدرامي، وهذا ما يهم الروائي بوصفه مبتكرا وليس مدون احداث، لذلك لا يعتد بمصداقيتها ولا الركون الى حقائق تاريخية مقترنة بها .
لم تكن (الحرب والسلام) لتولستوي، ولا (الأمل) لاندريه مالرو، و لا (كل شيء هادئ في الجانب الغربي ) لريمارك ولا (لمن تقرع الاجراس ) لهمنغواي، ولا خماسية عبد الرحمن منيف , ولا ثلاثية نجيب محفوظ ولا روايات عبد الخالق الركابي، فكلها ليست روايات تاريخية يمكن مراجعة التاريخ عن طريقها .. انها تتخذ من التاريخ خلفية مصحوبة بخيال الروائي الذي يضفي عليها ابعادا درامية لكي تقع في جنس الرواية.
شخصيا، اقرأ التاريخ من مصادره الموثوقة، لا من المنتصر ولا من المنكسر فكلاهما لا يعتد بدقته وعلميته وشهادته. والروائي ـ كما احسب ـ شاهد عصره، وليس شاهد ماضيه، الا على وفق منظور انساني تتفوق الحكمة والتجربة الحية في تفاصيله.
الرواية، فن البراعة والابتكار والخيال الملهم، والتاريخ مقترن بالزمن، زمن ثابت، ورواية تعمد الى تحريكه لكي يتفاعل الماضي مع الحاضر.
من هنا يفترض ان يهضم الروائي الاحداث التاريخية هضما جيدا حتى يتمكن من صياغة الومضات التاريخية الاستثنائية؛ لكي تكون زادا للحاضر والمستقبل، ومؤشراً الى الانسان هو المحرك الأساس للتاريخ الوثيقة وللرواية ـ الفن.
المسرحي والروائي عباس لطيف
غالبا ما يثار سؤال العلاقة بين التاريخ والسرد الروائي كما يصفه بول ريكور، والرواية سرد ولكن الكيفية والتوظيف هو نقطة الاختلاف بينهما.. ويتفرع عن هذا السؤال المركزي الكثير من الأسئلة والتأملات والفرضيات وفي مقدمتها: هل يعكس السرد الروائي الحقيقة التاريخية كما هي، أم يحقق أنزياحا دلاليا للوصول الى منطقة التأويل وخلق وجهات نظر ومنظومات جديدة وفاعلة.
ووفق هذا المفهوم ينبغي التفريق بين الرواية التاريخية، والتاريخ في الرواية.
والروائي بطبيعة هذا الفهم يختلف عن المؤرخ (الرسمي) والوقائعي، أنه يكتب نصا موازيا للتاريخ، لكنه ليس التاريخ بالضرورة. وقد لا يلتزم بالتراتب أو البناء الخطي للأحداث، بل ستستقي جزئيات أو مواقف وتناقضات معينة لكي يقدم رؤية تأويلية إسقاطيه للحدث التاريخي.
وبذلك تتحول الكتابة الى نوع من التأويل والكشف عن المسكوت عنه، وأركيولوجيا سرية لتقديم المضمر والغاطس والبنية العميقة، وفق صياغة جمالية وأدائية تختلف عن النسق التاريخي، ومحدداته وقواعد ارتكازه.
وليس كل التاريخ يصلح أن يكون عملا روائيا، وإلا سيصبح مجرد توثيق، فالكتابة الروائية للتاريخ هي انتقاء وبحث وكشف لا تهتم بالتاريخ بمعناه التراكمي بل تهتم بالحقائق والاسقاطات والاكتشافات وإضاءة الزوايا والمراحل وفق وعي القراءة الجديد. فالعمل الروائي هو بحد ذاته إعادة اكتشاف التاريخ وفق منظور جديد ومختلف، فهو كتابة واستخلاص واستشراف يعمل على خلق بيئة موازية للتاريخ وتقديمه وفق مجموعة من الأسئلة والجدل والكشف ولسي مجرد محمول سردي محايد وتوثيقي. الرواية تتعمل مع التاريخ بوصفه وقائع تتحول الى تاريخانية جديدة.