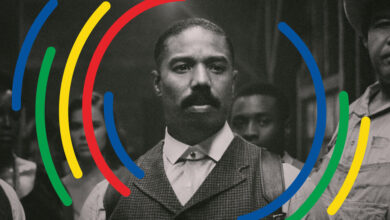مسارات التجريب في القصة المصرية القصيرة
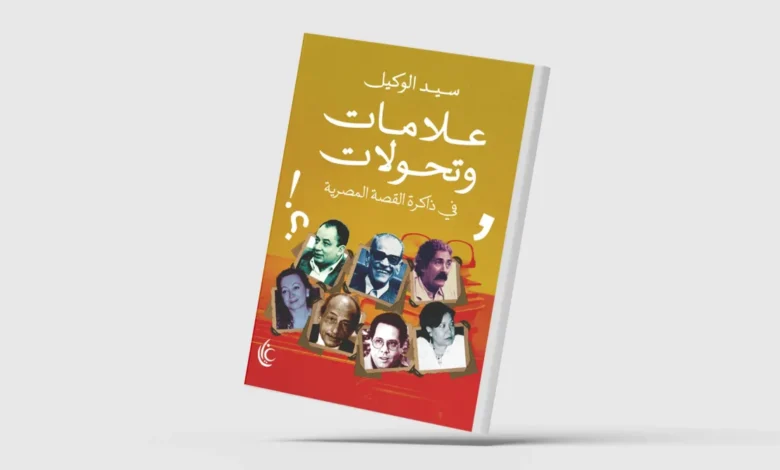
يسعى الناقد والروائي المصري سيد الوكيل، في كتابه «علامات وتحولات: في ذاكرة القصة المصرية» إلى الوقوف عند أهم محطات التجريب التقني في كتابة القصة القصيرة لدى عدد كبير من كتابها، بدءاً من مرحلة جيل الستينات مروراً بجيل الثمانينات، ووصولاً إلى الجيل الحالي، منطلقاً من أهمية التجريب في فن القص، وأنه ما يمنح النص القصصي جدارته الجمالية والمعرفية.
صدر الكتاب أخيراً عن دار «غايا» للنشر في القاهرة، ويتكون من مقدمة وفصل تنظيري ثم ثلاثة فصول تطبيقية، تمثل المتن الأكبر من الكتاب، فكل فصل منها يضم عدداً من القراءات في مجموعات قصصية مختلفة. في المقدمة يتوقف الوكيل عند جدل الأنواع الأدبية، والحدود الرهيفة بين القصة القصيرة والرواية تحديداً، وما بينهما من أنواع بينية مثل النوفيلا أو المتتالية القصصية، وما يثيره كثير من النصوص من جدل نقدي وحيرة عند تصنيفها النوعي فتبدو عصيةً على التحديد القطعي. ويشير إلى بدايات فن القصة، موضحاً أن «القصة نتاج عصر ازدهار الثورة الصناعية، وأحدُ مظاهر هذا العصر نهوض الوعي التقني بالعالم، وهو وعي ينفتح على معارف جمَّة، في المقابل انحسار الوعي الملحمي».
ويرى الوكيل أن هذا الفن ليس مجرد نوع أدبي ذي خصائص جمالية محددة، لكنه ظاهرة سياسية وثقافية، مرتبطة بحراك ثوري حدث لحظة تبلور القصة وظهورها للوجود فناً جديداً، ويذهب إلى أن «انبثاق القصة كظاهرة ثورية حرَّرها كثيراً من جاهزية البناء، فالرهان التقني خصب ومتعدد، يمتثل للأداء الفردي، والمهارات الخاصة، ويكشف عن النوازع التجريبية، وروح المغامرة».
الفصل الأول النظري، وعنوانه «ممكنات التعبير في القصة المعاصرة»، يحاول البرهنة على رحابة الفن القصصي، وانفتاحه على إمكانات التجريب بشكل أكبر من الرواية، رابطاً السرد القصصي بالذات الساردة، مما يمنحها طاقات تعبيرية خاصة، بعيداً عن أي قواعد أو قوانين أو تقنيات مسبقة ومحفوظة. ضمنياً يشير الكاتب هنا إلى صلة قربى بين القصة القصيرة وفن الشعر، بوصف الأخير حالة تعبير ذاتية في المقام الأول، ومن ثم فإن الطبيعة الغنائية تربط بين الفنين، ويؤكد أن «ذاتية التعبير في السرد القصصي، جعلت من كل نص تجربة جديدة تتخلق ذاتها الساردة لحظة كتابتها».
في الفصل الثاني «الراحلون في الذاكرة»، يقدم المؤلف قراءات تطبيقية في عدد من المجموعات القصصية لمجموعة من رموز السرد المصري في جيل الستينات، وبعض السبعينيين، بوصفهم من الآباء المؤسسين لحركة التجريب في القصة المعاصرة، فيتوقف في البداية عند دراسة رمزية ودلالات القناع والوحش القديم في قصتَي «بهو الأقنعة» و«صلاة الوحوش الآمنة» للكاتب سعد مكاوي، كما ينتقل إلى دراسة السرد القصصي لدى محمد مستجاب في مجموعاته «التاريخ السري لنعمان عبد الحافظ» و«قيام وانهيار آل مستجاب» و«ديروط الشريف» محللاً العلامات المتداخلة في سروده، وصعوبة تصنيفها النوعي بين القصة القصيرة والرواية. «بحيرة المساء» للكاتب إبراهيم أصلان كانت محط اهتمام هذا الفصل، حيث توقف عند توظيف الزمن ودلالاته وأبعاده المتنوعة في قصصها.
وفي قراءته مجموعة علاء الديب «وقفة قبل المنحدر»، يشير الوكيل إلى أن نصوصها متخفِّفة من الالتزام بطبيعة البناء السردي وعناصره المألوفة، كما أنها ممسوسة بمسحة من السيرة الذاتية، وبها قدر هائل من القلق الوجودي. وفي هذا الفصل أيضاً يقدم قراءات في مجموعات: «كتاب الأحوال» لمحمد كشيك، و«شتاء العري» ليوسف أبو رية، و«صباح وشتاء» للناقد الأكاديمي سيد البحراوي. وفي كل هذه القراءات يتوقف عند تململ الكاتب من التصنيف التقني الضيق والتقليدي لحدود النوع الأدبي، ومحاولات توسيع هذه الحدود وأجناسها، حتى إن البحراوي كتب على غلاف كتابه تصنيف «نصوص»، ليفتح المجال لكتابة بينية لا تلتزم بصرامة التحديد التقني للنوع الأدبي.
وينتقل الكاتب في الفصل الثالث «مساحات للتجريب»، إلى قراءة نصوص أدباء من جيل الثمانينات وما بعده، رغم تحفظه النظري على تقسيم الأدب إلى أجيال، لكنه يشير إلى أن وعياً جديداً ونصاً جديداً بدآ التشكُّل على نحو واضح في منتصف ذلك العقد، حيث بدأ واقع جديد يتشكل سياسياً واقتصادياً. ويصف أدباء تلك الحقبة بأنهم «جيل الجزر المعزولة، والخصوصيات الضيقة، والهويات الضائعة، والفرص المحدودة، وسيتحول نضاله من نضال ضد عدو متعين واضح، إلى نضال ضد عدو غامض ومتعدد، ليأخذ هذا الصراع طابعاً دون كيخوتياً، قد يتوجه إلى الذات أكثر من أي شيء آخر».
ويقدم الناقد في هذا الفصل قراءات لمجموعات «السماء على نحو وشيك» لعزت القمحاوي، و«حكايات البنت المسافرة» لمحمد عبد الحافظ ناصف، و«وجوه نيويورك» لحسام فخر، و«عشاء برفقة عائشة» لمحمد المنسي قنديل، وإن كان هذا الأخير من حيث التصنيف الجيلي ينتمي إلى السبعينات أكثر، ثم ينتقل إلى مجموعة من كتَّاب القرن الجديد مثل أحمد الملواني، وأحمد عبد الرحيم ومجموعته «العصر الذهبي للدليفري».
يركز الفصل الرابع والأخير «مطاردو الخيال وصوره المتعددة»، على انفتاح الخيال بشكل كبير في كتابة السرد القصصي، وعلى كتابة الأحلام، بوصفها تمثل أفقاً تجريبياً جديداً ومتسِعاً لفن القصة القصيرة، إذ تحلق هذه الأحلام في فضاء ذاتي لكاتبها، فلا تلتزم بالواقع وقضاياه، مشيراً إلى أن «مغامرة نجيب محفوظ في سرد الأحلام خلقت مساراً جديداً للقصة، يؤكد حضور الذات الساردة، واضمحلال المسافة بين الذات والموضوع، حتى تصبح الذات هي نفسها موضوع الحلم». وقد بدأ قراءة هذه السرديات بـ«أحلام فترة النقاهة» لنجيب محفوظ، ثم «أحلام الفترة الانتقالية» لمحمود عبد الوهاب، و«دفتر النائم» لشريف صالح، ثم محمد رفيع في «عسل النون»، موضحاً أنه يقدم سرداً بصرياً، عبر تشكيل أقرب إلى الصورة الفيلمية، كما يقدم في هذا الفصل قراءة في «خرائط التماسيح» لمحسن يونس، و«القطط أيضا ترسم الصور» للكاتب الشاب أحمد شوقي.
ويختتم الوكيل كتابه بتأكيد أن القصة القصيرة تمثل شكلاً مرناً قابلاً للتداخل والتماهي مع أشكال مختلفة، وأنها أكثر أشكال التعبير الأدبي قدرةً على مساجلة الواقع والتاريخ والذات معاً.