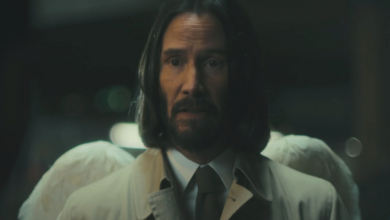المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية في مهرجان «كان»

محمد فارس الفارس: علينا صياغة التاريخ باستمرار
وُلِدَ المؤرّخُ محمد فارس الفارس في إمارةِ الشّارقةِ عامَ 1960، ويشغلُ حاليّاً منصبَ رئيسِ قسمِ الجودةِ بإدارةِ التّعليمِ المستمرِّ في وزارةِ التّربيةِ والتّعليمِ والشّبابِ بدولةِ الإماراتِ العربيّةِ المتّحدة. نالَ درجةَ الليسانس في الآدابِ (تخصّص تاريخ) من جامعةِ القاهرةِ عامَ 1984، ثمَّ دبلومَ الدّراساتِ العُليا من جامعةِ القدّيسِ يوسف بلبنانَ عامَ 1989، فالماجستير في التّاريخِ من الجامعةِ ذاتِها عامَ 1991 عن رسالةٍ بعنوان «التجمّعاتُ القبليّةُ ودورُها في تكوينِ الوحداتِ السّياسيّةِ في الخليجِ العربيِّ خلالَ القرنينِ السّابعَ عشرَ والثّامنَ عشر». وهو حاصلٌ أيضاً على درجةِ دكتوراه الدّولةِ في العلومِ الإنسانيّةِ والاجتماعيّةِ (فرع التّاريخ) من جامعةِ تونس الأولى عامَ 1999 عن أطروحةٍ موسومةٍ بـ«الأوضاع الاقتصاديّة في إماراتِ السّاحلِ 1862- 1965». هنا حوار معه استطلعنا من خلاله رأيَهُ حولَ أحدثِ إصداراتهِ «شريعةُ حمورابي أم شريعةُ إبراهيم؟»:
> أولاً، ما هيَ أهمُّ الأدلّةِ والبراهينِ الّتي تستندونَ إليها لإثباتِ فرضيّةِ التّزامنِ التّاريخيِّ بينَ النّبيِّ إبراهيمَ (عليهِ السّلام) والملكِ حمورابي؟
– فرضية تزامن النبي إبراهيم عليه السلام مع الملك البابلي الشهير حمورابي أتت بالصدفة، ومن خلال إعدادي لكتاب آخر بعنوان «من هو فرعون موسى؟»، حيث انطلقت في البحث بهذا الموضوع قبل حوالي 14 سنة، أثبت فيه أن الفرعون الذي بعث له موسى عليه السلام هو الفرعون أمنحوتب الثالث والد الفرعون الشهير أخناتون، مما يعني أن تاريخ وفاته وهو عام 1353 ق.م تقريباً هو عام خروج بني إسرائيل من مصر، وتبين لي أيضاً أن السنوات الـ430 التي كتبت بالتوراة على أنها كامل المدة التي مكثها بنو إسرائيل في مصر هي في واقع الأمر كامل المدة منذ عهد جدهم الأول إبراهيم عليه السلام، كما جاء في 4 مصادر مهمة هي: التوراة السامرية والتلمود وكتاب المؤرخ اليهودي جوزيفوس وكتاب المؤرخ أفريكانوس، ثم قمت بجمع الـ430 سنة مع سنة 1353 ق.م لأعرف في أي زمن عاش إبراهيم، وكانت المفاجأة أنه عاش في زمن الملك حمورابي، الذي حكم خلال الفترة من عام 1792ق.م إلى عام 1750 ق.م، وبعد البحث تبين أن كبار علماء الآثار ذكروا أن إبراهيم عاش في زمن حمورابي، منهم ليونارد وولي الذي قام بعمليات الحفر والتنقيب في أور بالعراق من عام 1922 حتى عام 1934، والبروفسور هوبرت غريم، والبروفسور سايس وغيرهم. كما ذكر هؤلاء العلماء وغيرهم أن «أمرافيل» الذي ذكر في التوراة هو حمورابي.
> في كتابكم، تطرحون فرضيةً جريئةً مفادُها أنَّ شريعةَ حمورابي مُستلهَمةٌ أو مُقتبَسةٌ من «شريعة إبراهيم»، كيف تبرهنون على هذا التأثير أو الاستمداد؟
– شريعة حمورابي أثارت جدلاً طويلاً منذ اكتشافها أوائل عام 1902، وهي مكتوبة على حجر من الديورايت، واكتشفت في مدينة سوسة المعروفة اليوم بـ«قلعة الشوش»، جنوب غرب إيران، وكان المذهل في تلك الشريعة أنها مشابهة لشريعة موسى عليه السلام، رغم أن موسى أتى بعد إبراهيم بأكثر من 400 سنة، وأهم قانون متشابه بين الشريعتين هو قانون «العين بالعين والسن بالسن»، وهذا القانون ذكره الله تعالى في القرآن في سورة «المائدة» على أنه فُرض على بني إسرائيل في التوراة، مما يعني أن هذا النص في التوراة نص أصلي ولم يطله التحريف، وكانت هناك فرضية لأن اليهود أثناء السبي البابلي هم من وضعوا هذا النص من شريعة حمورابي في التوراة، ولكن هذه الفرضية لم تكن مقبولة من كثير من المؤرخين، وهنا يبرز السؤال المهم: من أين أتى حمورابي بهذا النص وهو يسبق موسى بمئات السنين؟ لا يوجد إلا تفسير واحد لذلك، وهو أن شريعة حمورابي هي شريعة مستمدة من مصدر ما، وتحديداً من شريعة سماوية لكون موادها تنبئ بذلك، وبما أن الشرائع السماوية متشابهة في النصوص لأنها من المصدر نفسه، وأثبتنا أن إبراهيم كان معاصراً لحمورابي، فمعنى ذلك أن حمورابي أخذ شريعة إبراهيم ونسبها لنفسه، وقمت بعمل مقارنة بين شريعة حمورابي وشريعة موسى والشريعة الإسلامية، وتبين لي أنها متشابهة، ويمكننا أن نلاحظ أيضاً أن «صحف إبراهيم وموسى» ذكرتا معاً في سورتي «الأعلى» و«النجم»، كون تشريعاتهما متشابهة، مما يعني أن شريعتي إبراهيم وموسى كانتا متشابهتين بالنصوص.

> نودُّ منكم إضاءةً أوسع حول شريعةِ حمورابي: طبيعتِها، وأبرزِ سماتِها، والسياقِ الحضاريِّ والتشريعيِّ الذي ظهرت فيه؟
– تتألف نصوص مواد مسلة حمورابي من 44 حقلاً أو عموداً من الكتابة المسمارية التي تنقسم إلى مقدمة، ونص الشريعة، ويشتمل على 282 مادة، وخاتمة. ونقشت هذه القوانين على ثلاث كتل كبيرة من حجر الديورايت، وجمعت مع بعضها البعض لتشكل نصاً مخروطياً. ومما يلفت النظر في تلك الشريعة، أنها أتت شاملة لكل شيء يخص حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية، وبتفاصيل تتناول أموراً تحث عليها الديانات السماوية، مثل الإحسان للوالدين، والنهي عن القتل وعن الزنى، وعدم التعدي على مال اليتيم، والنهي عن الغش والسرقة وشهادة الزور، والحث على الوفاء بالعهود، إضافة إلى أحكام بالقصاص في القتل وزنا المحارم والربا والسرقة، وأحكام تخص العبودية والطلاق وغيرها، بالتالي لا يمكن أن تأتي هذه القوانين المنظمة لحياة المجتمع، التي تحث على الفضيلة والنزاهة، إضافة إلى التمسك بالقيم فيما يخص العلاقات الاجتماعية والتجارية وبهذا التفصيل، في زمن كانت فيه معظم تلك الأمور عادات وتقاليد طبيعية وغير مستهجنة، وهناك نقطة مهمة، وهي أن التشريعات البشرية تأتي معظمها من الشرائع السماوية، ثم تصاغ حسب الرغبات، فمن أين أتى حمورابي، وهو ملك وثني، ويحكم مجتمعاً وثنياً بشريعة موادها مشابهة للشرائع السماوية، وتضع قوانين للربا في حين أن الربا كان يعدُّ من أهم الأسس التي قامت عليها المعاملات التجارية في تلك الفترة.
> وما هي، في تقديركم، طبيعةُ العلاقةِ بين ما سميتموه «شريعة إبراهيم» ومبادئ الدياناتِ التوحيديةِ الأولى؟
– شريعة الله سبحانه وتعالى التي أتى بها الأنبياء واحدة، لأنها من مصدر واحد، يقول تعالى في سورة الشعراء «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه»، هذا فيما يخص الثوابت الرئيسية، وأولها التوحيد، حيث إن الأنبياء بعثوا لأمم وشعوب وثنية تعبد النجوم والكواكب والأصنام، ويوجد بها كل المفاسد مثل القتل والسرقة والزنا والربا وغيرها، ولذلك نجد أن ما ورد في الشرائع يكاد يكون متشابهاً، ولكن هناك أحياناً بعض الاختلافات في الأمور الثانوية، ولذلك نجد تشابهاً فيما يخص الشرائع بين الديانة الإسلامية والديانة اليهودية.
> كم من الوقت استغرقت رحلتُكم البحثيةُ للتوصلِ إلى هذه الاستنتاجاتِ وتوثيقِها؟
– بدأت رحلتي البحثية عام 2011م، وقمت منذ ذلك الوقت بزيارات إلى متاحف برلين والبريطاني في لندن ومتحف كونست هيستوريشس في فيينا، ومتحف اللوفر في باريس، حيث توجد مسلة حمورابي منذ اكتشافها، كما قمت بمراسلة متحف بغداد وتفضلوا بإرسال كل الصور المطلوبة، وأرسل لي أحد الأصدقاء صوراً للمنطقة التي كانت تشغلها مدينة أور التي يقال إن إبراهيم ولد فيها.
> ما هي طبيعةُ المصادرِ والوثائقِ التي استندتُم إليها في هذا البحث المهم، وهل كان من بينها ما هو نادرٌ أو غيرُ متداولٍ على نطاقٍ واسع؟
– اعتمدت على المصادر الأصلية بشكل كامل، فعكفت في البداية على قراءة كل الآيات القرآنية وتفسيرها فيما يخص قصة موسى عليه السلام وفرعون، وما يخص قصة إبراهيم عليه السلام، إضافة إلى التوراة والتلمود بعد شرائي النسخ الأصلية منهما، وقمت بشراء كمية كبيرة من المراجع الأصلية للبحث من موقع «أمازون» مثل كتب المؤرخين القدامى: جوزيفوس، ومانيثون، ويوليوس أفريكانوس، ويوسيبيوس وغيرهم، إضافة إلى كتب كبار علماء الآثار مثل ليوناردو وولي الذي نقب في العراق وجيمس بريستد وسيريل الدريد وفلندرز بتري وإيريل كوزلوف ودونالد ريدفورد وغيرهم، واستغرقت فترة القراءة عدة سنوات قبل البدء بالكتابة.
> كتابُكم الثاني، الذي صدر بالتزامن مع الكتاب الأول، يتناول، حسب فهمنا، التاريخَ القديم لبني إسرائيل منذ النشأةِ حتى سنواتِ الاضطهادِ في مصر. هل يمكن أن تُعطونا لمحةً عن أبرزِ محاور هذا الكتاب ومنهجيتكم فيه؟
– يتناول كتابي «من يوسف إلى موسى عليهما السلام» قصة التكوين الأولى لبني إسرائيل، وبمعنى أدق بدايتهم الأولى، حيث إن إسرائيل هو يعقوب والد يوسف عليهما السلام كما جاء في القرآن والتوراة، وبني إسرائيل هم حصراً يوسف وإخوته الأحد عشر وذريتهم، وهؤلاء كانوا يعيشون في صحراء النقب جنوب الأردن، وأثبت أن يوسف تم بيعه في مصر في الفترة التي حكم فيها الهكسوس مصر، والهكسوس عرب على ديانة التوحيد، ولذلك قاموا بتعيين يوسف بمنصب رفيع لديهم، وبعد طرد الهكسوس من مصر، بدأت محنة بني إسرائيل، حيث اعتبرهم المصريون خونة كونهم متعاونين مع الهكسوس، وبدأ فراعنة الأسرة 18 التي تلت الهكسوس باضطهادهم، وكان يتم قتل المواليد الذكور، كما جاء في القرآن، إلى أن جاء موسى إلى الفرعون الرابع في الاضطهاد وهو أمنحوتب الثالث، وهو ما أثبت أنه فرعون موسى، وهو والد الفرعون الشهير أخناتون.

> تَكتنِفُ الروايات التاريخية لبداياتِ بني إسرائيل اختلافاتٌ وتفسيراتٌ مُتعددة، ما هي أبرزُ هذه الاختلافات في تقديركم، وكيف تعاملتُم معها في ضوءِ ما قدَّمه المؤرخون السابقون والمعاصرون؟
– معظم الدراسات العربية التي ظهرت عن بني إسرائيل، إما أن تقص القصة القرآنية فقط دون المواءمة مع الأحداث التاريخية، أو تنقل من المصادر الأجنبية المعتمدة على الرواية التوراتية، ولذلك تم تكرار معظم المعلومات التاريخية في تلك الكتب، وهذا ما حرصت على تجنبه في كتابي، حيث قدمت رواية جديدة موثقة.
> ما هو موقعُ القرآنِ الكريمِ كمصدرٍ في أبحاثِكم المتعلقةِ بالتاريخ القديم لبني إسرائيل، وكيف وازنتم بينه وبين المصادرِ التاريخيةِ والأثريةِ الأخرى؟
– من يقرأ القرآن جيداً، سيجد أن قصة بني إسرائيل تحوي تفاصيل دقيقة أكثر من التوراة، ولكن لغة القرآن البليغة تحتاج إلى وقت لفهمها، كما أن قصة بني إسرائيل في القرآن أتت في عدة سور، في حين أتت في التوراة متسلسلة، ولذلك لجأ معظم الباحثين إلى القصة التوراتية لسهولة النقل منها، ولأن المراجع الأجنبية تعتمد عليها، وبالتالي أصبحت هناك عملية نقل للمعلومات دون الاهتمام بما جاء في القرآن.
> هل يمكنُ اعتبارُ ما تطرحونه في هذين الكتابين محاولةً لتقديمِ قراءةٍ جديدةٍ أو إعادةِ نظرٍ في بعضِ فصولِ التاريخِ القديم للمنطقة؟
– ما طرحته في الكتابين هو دراسة تعتمد على ما ذكره كبار المؤرخين وعلماء الآثار، وما يقابله في القرآن الكريم، وما تحويه التوراة من المتشابه مع القرآن، وهذا الأمر احتاج مني فترة طويلة من الإنجاز، وسأكون سعيداً بفتح باب النقاش حول هذا الموضوع. وُلِدَ المؤرّخُ محمد فارس الفارس في إمارةِ الشّارقةِ عامَ 1960، ويشغلُ حاليّاً منصبَ رئيسِ قسمِ الجودةِ بإدارةِ التّعليمِ المستمرِّ في وزارةِ التّربيةِ والتّعليمِ والشّبابِ بدولةِ الإماراتِ العربيّةِ المتّحدة.
نالَ درجةَ الليسانس في الآدابِ (تخصّص تاريخ) من جامعةِ القاهرةِ عامَ 1984، ثمَّ دبلومَ الدّراساتِ العُليا من جامعةِ القدّيسِ يوسف بلبنانَ عامَ 1989، فالماجستير في التّاريخِ من الجامعةِ ذاتِها عامَ 1991 عن رسالةٍ بعنوان «التجمّعاتُ القبليّةُ ودورُها في تكوينِ الوحداتِ السّياسيّةِ في الخليجِ العربيِّ خلالَ القرنينِ السّابعَ عشرَ والثّامنَ عشر». وهو حاصلٌ أيضاً على درجةِ دكتوراه الدّولةِ في العلومِ الإنسانيّةِ والاجتماعيّةِ (فرع التّاريخ) من جامعةِ تونس الأولى عامَ 1999 عن أطروحةٍ موسومةٍ بـ«الأوضاع الاقتصاديّة في إماراتِ السّاحلِ 1862- 1965».
هنا حوار معه استطلعنا من خلاله رأيَهُ حولَ أحدثِ إصداراتهِ «شريعةُ حمورابي أم شريعةُ إبراهيم؟»: